كيف صاغ الكواكبي سؤال النهضة وكيف حدّد سبب الفتور في حال الأمة؟!
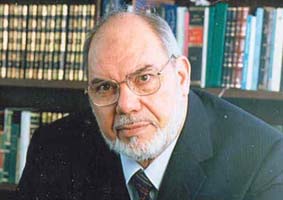
المشهد الثقافي والفكري الراهن لا يقل مأساويةً واضطراباً عن نهاية القرن ال19
(د. طه جابر العلواني)
كيف تقوّمون المشهد الثقافي العربي الراهن؟ وهل استطاع المفكّر العربي أن يتغلّب على أسئلة وسجالات سلفه في نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، أم أنّه لمّا يزل يكرّر ذاته عبر إعادة إنتاج تلك الاستفهامات من دون أن يلج عتبة الإبداع والتأسيس؟!
هذا السؤال طرحته مجلة “الحوار” في عددها الصادر في مطلع العام 1999، وأجاب عنه المفكر الإسلامي الراحل الدكتورطه جابر العلواني (4 مارس/آذار 1935 – 2016) في إطار جوابٍ فكري شامل، نقتطف منه الآتي:
الواقع العربي الراهن واقع مأساويّ، والحقائق الموضوعيّة التي تحيط به لا تسمح بإزاحة دواعي اليأس وعوامل الإحباط من طريق العقل والنفس، والمفكّر ابن بيئته لا ينفصل عنها حتى لو اتجه نحو اللا انتماء لا سمح الله. والأمّة القطب التي تكوّنت وتشكّلت بنور هداية القرآن المعجز الخالد تعيش حالة أزمة حقيقية لم يعد جانبها البرّاني إلا أخفّ جوانبها. أمّا جانبها الجوّاني فهو قاتم مظلم يحتاج إلى حفر ذهني عميق، وبعيد الغور في تجاويف الدماغ العربي والعقل العربي والنفس العربية ليصل إلى أعماق الأزمة ويحيط بها لعلّه يتمكّن بعد ذلك من تبيّن معالم الخروج منها أو تجاوزها.
والمشهد الثقافي والفكري الذي يمكن لواقعٍ كهذا أن يفرزه لا شكّ أنّه مشهد لا يقل عنه مأساويةّ واضطراباً. فبعد سائر ضروب الإخفاق التي شهدتها الأمة في الساحات المختلفة، شهدت إفلاساً فكريا تمثّل بفشلٍ ذريع لما يلي:
فشل النظريات القومية التي اقتُبست من الغرب – حيث أخفقت فكرياً وعمليّاً في بناء دولة عربية أو دول لها من الخصائص ما يجعل منها كيانات متينة سواء منها تلك التي لاحظت بعض الخصوصيات العربية والإسلامية، أو تلك التي تجاوزت تلك الخصوصيات.
فشل النظريات الاشتراكية، ماركسية كانت أو غيرها، حيث أخفقت وفشلت كلها في إيجاد أي نموذج مقبول، وحطّمت وهي في طريقها إلى الصعود ثم الهبوط كثيراً ممّا كان قائماً من البنى التحتية، وحطّمت جملة من العلاقات التي كانت تربط بين أجزاء مجتمعاتنا القديمة.
كما أنّ محاولات تطبيق ليبرالية محدودة في إطار رأسمالي فشلت فشلاً لم يكن بأقل من فشل الماركسية وغيرها وسرعان ما أفسحت المجال إلى انقلابات عسكرية أتت على مقدّرات البلاد والعباد، وحوّلت فصائل الأمّة إلى ما يشبه القطعان السائمة تحمل عقلية عوام وطبيعة قطيع ونفسية عبد.
بعد تلك الإخفاقات كلها بدت “الحركات الدينية” المنطلقة من تحت مظلّة “الصحوة” تنادي بأنّ “الإسلام هو الحل”، وأقبلت الجماهير عليها منتظرة ذلك الحل. وقدّمت أفكاراً كثيرة ركّز بعضها على تطبيق الشريعة وتنفيذ الأحكام وإقامة الحدود. وبدأ البعض الآخر يبحث عن صِيَغٍ توفيقية مع ما كان يرفضه من قبل جملةً وتفصيلا. وحُطِّمت بعض المحاولات قبل أن تبدأ. وبعض المحاولات استطاعت أن تقف على قدميها في حدودٍ وحتى حين. وبقي الواقع العربي التقليدي واقفاً في الوحل بثبات يتضاحك ساخراً من سائر المحاولات التغييرية ومنطلقاته، ويعلن للجميع أنّه قادر على استلاب أيّة أفكار إصلاحية وتحويلها إلى وسائل تعزّزه. فواقعنا كمن يحمل ميكروباً ضخماً متوحشاً يلتهم كلّ شيء يقدّم له حتى الدواء فإنّه يغيّر طبيعته ويستولي عليه ويحيله إلى غذاء له يعزّز وحشيته وعنفوانه؛ لأنه واقع لم تكتشف حقيقته بعد، ولم تعرف مركّباته، ولا القوانين التي صاغت تلك المركّبات. فالمركّبات الطائفية والعشائرية والإقليمية، والأيديولوجيات الموروثة والحادثة تعزّز من الانحرافات وعوامل التفكيك في الواقع الاجتماعي والتاريخي بشكل ما يجعل هذا الواقع المرير أقوى وأعتى من كل ما يقدم له من حلول. فما الحلّ؟
قبل أن تدفعنا عقلية “التقليد” إلى البحث عن الحلّ الجاهز – كما حصل في السابق- أودّ أن أؤكد بأننا، جميعا، مهما كانت انتماءاتنا الفكرية والأيديولوجية أو العشائرية أو المذهبية أو الإقليمية وحتى القومية: مطالبون برفع درجة التوتر والقلق في نفوسنا إلى مستوى يسمح بالقيام بمراجعات جادة ومخلصة لمحاولاتنا وآرائنا وأفكارنا، وإعادة طرح السؤال العتيد “أين الخطأ وأين الحل” من جديد، إذ قد أثبت الواقع أنْ لا أحد أحاط بالحقيقة. فذلك من أكثر الأمور المساعدة فاعليّة في تبيّن معالم المشهد الذي نعيش فيه ورسم مختلف أبعاده.
أودّ أن أعود بقرّائي الكرام لنرى كيف صاغ الكواكبي (عبد الرحمن أحمد بهائي محمد مسعود الكواكبي (1271-1320 ه 1855-1902 م)سؤال النهضة في مؤلفه “أمّ القرى” ثمّ في “طبائع الاستبداد”، ثمّ نبحث في الصياغات المعاصرة لنرى ما إذا كانت يمكن أن تقاس به أو إليه؟ وما إذا كانت يمكن أن تتجاوزه وتأتي بالبديل الجديد.
ولنقرأ معاً محضر “الاجتماع السابع” من اجتماعات جمعية “أم القرى” التي لخّص المجتمعون فيه (كما تخيّل ذلك الكواكبي) ما سمّوه بسبب “الفتور” في هذه الأمّة. هذا الفتور الذي أدّى –في نظرهم- إلى تراجع أمتنا وتقاعسها عن تحقيق أسباب النهوض والتجديد، وسأورده بنصّه لئلا يتكلّف القارئ عناء الذهاب إلى المصدر المذكور للبحث في تفاصيل السؤال والجواب من ناحية، ولأنني أودّ التعليق على المحضر واستصحاب القارئ معي في رحلةٍ فيه وحوله.
(منقول عن كتاب الكواكبي “أم القرى”):
“الاجتماع السابع” – يوم الأربعاء الرابع والعشرين من ذي القعدة سنة 1316 هجرية (5-4-1899 ميلاية)
في صباح اليوم المذكور انتظمت الجمعية وقرِىء الضبط السابق حسب القاعدة المرعيّة.
قال الأستاذ الرئيس مخاطباً السيد الفراتي: إنّ الجمعية لتنتظر منك فوق همّتك في عقدها وقيامك بمهمّتها التحريرية، أن تفيدها أيضاً رأيك الذاتي في سبب الفتور المبحوث فيه، وذلك بعد أن تقرّر لها مجمل الآراء التي أوردها الأخوان الكرام حيث أحطت بها علماً مكرّراً بالسمع والكتابة والقراءة والمراجعة فأنت أجمعنا لها فكرا.
هذا والجمعية ترجو الفاضل الشاميّ والبليغ الاسكندريّ لأن يشتركا في ضبط خطابك بأن يتعاقبا في تلقي الجمل الكلاميّة وكتابتها، لأنّهما كباقي الأخْوان لا يعرفان طريقة الاختصار الخطّي المستعمل في مثل هذا المقام. (يشير إلى الاختزال).
نظر الفاضل الشاميّ إلى رفيقه واستلمح من القول ثم قال: إنّنا مستعدان للتشرّف بهذه الخدمة.
قال السيد الفراتي: حبّاً وطاعة وإن كنت قصير الطول، كليل القول، قليل البضاعة. ثم انحرف عن المكتبة فقام مقامه الفاضل الشاميّ والبليغ الاسكندريّ، وما لبث أن شرع في كلامه، فقال:
يستفاد من مذكّرات جمعيتنا المباركة أنّ هذا الفتور المبحوث فيه ناشئ عن مجموع أسبابٍ كثيرة مشتركة فيه، لا عن سببٍ واحد أو أسباب قلائل تمكن مقاومتها بسهولة. وهذه الأسباب منها أصول، ومنها فروع لها حكم الأصول. وكلّها ترجع إلى ثلاثة أنواع: وهي أسباب دينية، وأسباب سياسية، وأسباب أخلاقية. وإنّي أقرأ عليكم خلاصاتها من جدول الفهرست الذي استخرجته من مباحث الجمعية رامزاً للأصول منها بحرف (الألف) وللفروع منها بحرف (الفاء)، وهي:
النوع الأول: الأسباب الدينية:
- تأثير عقيدة الجبر في أفكار الأمّة (أ).
- تأثير المزهدات في السعي والعمل وزينة الحياة (ف).
- تأثير فن الجدل في العقائد الدينية (أ).
- الاسترسال في التخالف والتفرّق في الدين (أ).
- الذهول عن سماحة الدين وسهولة التديّن به (أ).
- تشديد الفقهاء المتأخرين في الدين خلافاً للسلف (أ).
- تشويش أفكار الأمّة بكثرة تخالف الآراء في فروع أحكام الدين (ف).
- فقد إمكان مطابقة القول للعمل في الدين بسبب التخليط والتشديد (ف).
- إدخال العلماء المدلسين على الدين مقتبسات كتابية وخُرافات وبِدَعاً مضرّة (أ).
- تهوين غلاة الصوفية الدين وجعلهم إياه لهواً ولعبا (ف).
- إفساد الدين بتفنن المداجين بمزيدات ومتْروكات وتأويلات (ف).
- إدخال المدلسين والمقابريّة على العامّة كثيراً من الأوهام (أ).
- خلع المنجمين والرمّالين والسّحرة والمشعوذين قلوب المسلمين بالمرهبات (ف).
- إيهام الدّجالين والمداجين أنّ في الدين أموراً سرّية وأنّ العلم حجاب (أ).
- اعتقاد منافاة العلوم الحكمية والعقلية للدين (أ).
- تطرّق الشرك الصريح أو الخفيّ إلى عقائد العامّة (ف).
- تهاون العلماء العاملين في تأييد التوحيد (ف).
- الاستسلام للتقليد وترك التبصّر والاستهداء (ف).
- التعصب للمذاهب ولآراء المتأخرين وهجر النصوص ومسلك السلف (ف).
- الغفلة عن حكمة الجماعة والجمعة وجمعيّة الحج (أ).
- العناد على نبذ الحرية الدينية جهلاً بمزيّتها (ف).
- التزام ما لا يلزم لأجل الاستهداء من الكتاب والسنّة (ف).
- تكليف المسلم نفسه ما لم يكلفه به الله وتهاونه فيما هو مأمور به (ف).
النوع الثاني : الأسباب السياسية:
- السياسة المطلقة من السيطرة والمسؤولية (أ).
- تفرّق الأمّة إلى عصبيّات وأحزاب سياسية (ف).
- حرمان الأمّة من حرية القول والعمل وفقدانها الأمن والأمل (ف).
- فقد العدل والتساوي في الحقوق بين طبقات الأمّة (ف).
- ميل الأمراء طبعاً للعلماء المدلسين وجهلة المتصوفين (ف).
- حرمان العلماء العاملين وطلاب العلم من الرزق والتكريم (أ).
- اعتبار العلم عطيّة يحسن بها الأمراء على الأخصاء وتفويض خدمة الدين للجهلاء (أ).
- قلب موضوع أخذ الأموال من الأغنياء وإعطائها للفقراء (أ).
- تكليف الأمراء القضاة والمفتين أموراً تهدّم دينهم (ف).
- إبعاد الأمراء النبلاء والأحرار وتقريبهم المتملقين والأشرار (أ).
- مراغمة الأمراء السراة والهداة والتنكيل بهم (ف).
- فقد قوة الرأي العام بالحجر والتفريق (ف).
- حماقة أكثر الأمراء وتمسّكهم بالسياسات الخرقاء (ف).
- إصرار أكثر الأمراء على الاستبداد عناداً واستكباراً (ف).
- انغماس الأمراء في الترف ودواعي الشبهات وبعدهم عن المفاخرة بغير الفخفخة والمال (ف).
- حصر الاهتمام السياسي بالجباية والجندية فقط (أ).
النوع الثالث: الأسباب الأخلاقية:
- الاستغراق في الجهل والارتياح إليه (أ).
- استيلاء اليأس من اللحاق بالفائزين في الدين والدنيا (ف).
- الإخلاد إلى الخمول ترويحاً للنفس (ف).
- فقد التناصح وترك البغض في الله (أ).
- انحلال الرابطة الدينية الاحتسابيّة (أ).
- فساد التعليم والوعظ والخطابة والإرشاد (ف).
- فقد التربية الدينية والأخلاقية (أ).
- فقد قوّة الجمعيات وثمرة دوام قيامها (أ).
- فقد القوّة المالية الاشتراكية بسبب التهاون في الزكاة (أ).
- ترك الأعمال بسبب ضعف الآمال (ف).
- إهمال طلب الحقوق العامة جبناً وخوفاً من التخاذل (ف).
- غلبة التخلّق بالتملّق تزلّفاً وصغارا (ف).
- تفضيل الارتزاق بالجندية والخدم الأميرية على الصنائع (ف).
- توهّم أنّ علم الدين قائم في العمائم وفي كلّ ما سطّر في كتاب (ف).
- معاداة العلوم العالية ارتياحاً للجهالة والسفالة (أ).
- التباعد عن المكاشفات والمفاوضات في الشئون العامة (أ).
- الذهول عن تطرّق الشرك وشآمته (أ).
ثمّ قال السيد الفراتيّ: هذه هي خلاصات أسباب الفتور التي أوردها أخوان الجمعيّة، وليس فيها مكرّرات كما يُظن. وحيث كان للخلل الموجود في أصول إدارة الحكومات الإسلامية دخل مهم في توليد الفتور العام، فإنّي أضيف إلى الأسباب التي سبق البحث فيها من قبل الأخوان الكرام الأسباب الآتية، أُعدّدها من قبيل رؤوس مسائل فقط، حيث لو أردت تفصيلها وتشريحها لطال الأمر ولخرجنا عن صدد محفلنا هذا.
والأسباب التي سأذكرها هي أصول موارد الخلل في السياسة والإدارة الجاريتين في المملكة العثمانية، التي هي أعظم دولة يهمّ شأنها عامّة المسلمين. وقد جاءها أكثر هذا الخلل في الستين سنة الأخيرة، أي بعد أن اندفعت لتنظيم أمورها، فعطّلت أصولها القديمة ولم تحسن التقليد ولا الإبداع، فتشتّت حالها ولا سيّما في العشرين سنة الأخيرة التي ضاع فيها ثلثا المملكة؛ وخرب الثلث الباقي وأشرف على الضياع لفقد الرجال وصرف السلطان قوة سلطنته كلّها في سبيل حفظ ذاته الشريفة وسبيل الإصرار على سياسة الانفراد.
وأمّا سائر الممالك والإمارات الإسلامية فلا تخلو أيضاً من بعض هذه الأصول، كما أنّ فيها أحوالاً أخرى أضرّ وأمرّ يطول بيانها واستقصاؤها. والأسباب المراد إلحاقها ملخّصة هي:
الأسباب السياسية والإدارية العثمانيتين:
- توحيد قوانين الإدارة والعقوبات، مع اختلاف طبائع أطراف المملكة واختلاف الأهالي في الأجناس والعادات 1 (أ).
- تنويع القوانين الحقوقية وتشويش القضاء في الأحوال المتماثلة (أ).
- التمسّك بأصول الإدارة المركزية مع بعد الأطراف عن العاصمة وعدم وقوف رؤساء الإدارة في المركز على أحوال تلك الأطراف المتباعدة وخصائص سكانها (ف).
- تشويش الإدارة بعدم الالتفات لتوحيد الأخلاق المسالك في الوزراء والولاة والقواد، مع اضطرار الدولة لاتخاذهم من جميع الأجناس والأقوام الموجودين في المملكة بقصد استرضاء الكلّ (ف).
- التزام المخالفة الجنسية في استخدام العمّال بقصد تعسّر التفاهم بين العمال والأهالي، وتعذّر الامتزاج بينهم لتأمن الإدارة غائلة الاتفاق عليها (ف).
- التزام تفويض الإمارات المختصّة عادةً ببعض البيوت، كإمارة مكد وإمارات العشائر الضخمة في الحجاز والعراق والفرات لمن لا يحسن إدارتها، لأجل أن يكون الأمير منفوراً ممّن ولّي عليهم مكروهاً عندهم فلا يتفقون معه ضدّ الدولة (أ).
- التزام توليد بعض المناصب المختصّة ببعض الأصناف كالمشيخة الإسلاميّة والسر عسكرية لمن يكون منفوراً في صنفه من العلماء أو الجند، لأجل أن لا يتفق الرئيس والمرؤوس على أمرهم 3 (ف).
- التمييز الفاحش بين أجناس الرعية في “الغنم والغرم”4.
- التساهل في انتخاب العمال والمأمورين والإكثار منهم بغير لزوم، وإنّما بقصد إعاشة العشيرة والمحاسيب والمتملّقين الملحين.
- التسامح في المكافأة والمجازاة تهاوناً بشؤون الإدارة حسنت أم ساءت، كأنّ ليس للملك صاحب.
- عدم التفات لرعاية المقتضيات الدينية كوضع أنظمة مصادمة للشرع بدن لزوم سياسي مهم، أو مع اللزوم ولكن بدون اعتناء بتفهيمه للأمّة والاعتذار لها جلباً للقناعة والرضا5.
- تضييع حرمة الشرع وقوة القوانين بالتزام عدم اتباعها وتنفيذها والإصرار على أن تكون الإدارة نظامية اسماً، إدارية فعلاً6.
- التهاون في مجاراة عادات الأهالي وأخلاقهم ومصالحهم استجلاباً لمحبّتهم القلبية فوق طاعتهم الظاهرية.
- الغفلة أو التغافل عن مقتضيات الزمان ومباراة الجيران وترقية السكان بسبب عدم الاهتمام بالمستقبل.
- الضغط على الأفكار المتنبّهة بقصد منع نموّها وسموّها وإطلاعها على مجاري الإدارة، محاسنها ومعايبها، وإن كان الضغط على النمو الطبيعي عبثاً محضا،، ويتأنى منه الإغراء والتحفز وينتج عنه الحقد على الإدارة.
- تمييز الأسافل أصلاً وأخلاقاً وعلماً وتحكيمهم في الرقاب الحرّة وتسليطهم على أصحاب المزايا، وهذا التهاون بشأن ذوي الشؤون يستلزم تسفل الإدارة.
- إدارة بيت المال إدارة إطلاق بدون مراقبة، وجزاف بدون موازنة، وإسراف بدون عتاب، وإسلاف بدون حساب، حتى صارت المملكة مديونة للأجانب بديون ثقيلة توفى بلاداً ورقاباً ودماءً وحقوقا.
- إدارة المصالح المهمة السياسية والملكية بدون استشارة الرعية ولا قبول مناقشة فيها. وإن كانت إدارة مشهودة المضرّة في كل حركة وسكون.
- إدارة الملك إدارة مداراة وإسكات للمطلعين على معايبها حذراً من أن ينفثوا ما في الصدور فتعلم العامة حقائق الأمور، والعامّة من إذا علموا قالوا فعلوا وهناك الطامّة الكبرى.
- إدارة السياسة الخارجية بالتزلّف والإرضاء والمحاباة بالحقوق والرشوة بالامتيازات والنقود، تبذل الإدارة ذلك للجيران بقابلة تعاميهم عن المشاهد المؤلمة التخريبيّة، وصبرهم على الروائح المنتنة الإدارية. ولولا تلك المشاهد والروائح لما وجد الجيران وسيلة للضغط مع ما ألقاه الله بينهم من العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة.
ثم قال السيد الفراتيّ: إنّ بعض هذه الأسباب التي ذكرتها، هي أمراض قديمة ملازمة لإدارة الحكومة العثمانية منذ نشأتها أو منذ قرون، وبعضها أعراض وقتية تزول بزوال محدثها، وربما كان يمكن الصبر عليها لولا الخطر قرب والعياذ بالله من القلب كما أشار إليه الأستاذ الرئيس في خطابه الأول7.
ثم قال: ويلتحق بهذه الأسباب بعض أسباب شتى أفصلها بعد تعدادها إلحاقاً بالخلاصات، وهي:
أسباب شتّى:
– عدم تطابق الأخلاق بين الرعية والرعاة.
– الغرارة أي الغفلة عن ترتيب شؤون الحياة.
– الغرارة عن لزوم توزيع الأعمال والأوقات.
– الغرارة عن الإذعان للإتقان.
– الغرارة عن موازنة القوة والاستعداد.
– ترك الاعتناء بتعليم النساء.
– عدم الالتفات للكفاءة في الزوجات.
– الخور في الطبيعة، أي سقوط الهمّة.
– الاعتزال في الحياة والتواكل.
أمّا عدم التطابق في الأخلاق بين الرعاة والرعيّة، فله شأن عظيم كما يظهر للمتأمّل المدقّق في تواريخ الأمم من أنّ أعاظم الملوك الموفقين والقواد الفاتحين كالاسكندرين، وعمر وصلاح الدين رضي الله عنهما، وجنكيز والفاتح وشرلكان الألماني وبطرس الكبير وبونابرت، لم يفوزوا في تلك العظائم إلا بالعزائم الصادقة مع مصادقة تطابقهم مع رعاياهم وجيوشهم في الأخلاق والمشارب تطابقاً تاماً، بحيث كانوا رؤوسا حقاً لتلك الأجسام لا كرأس جمل على جسم ثور أو بالعكس. وهذا التطابق وحده يجعل الأمّة تعتبر رئيسها رأسها، فتتفانى دون حفظه ودون حكم نفسها بنفسها، حيث لا يكون لها في غير ذلك فلاح أبداً كما قال الحكيم المتنبي:
إنّما الناس بالملوك وهل يفلح عرب ملوكها عجم
وممّا لا خلاف فيه أنّ من أهمّ حكمة الحكومات أن تتخلّق بأخلاق الرعية، وتتّحد معها في عوائدها ومشاربها ولو في العوائد غير المستحسنة في ذاتها. ولا أقل من أن توفق لاجتذابهم إلى لغتها فأخلاقها فجنسيتها، كما فعل الأمويون والعباسيون والموحّدون، وكما تهتم به الدول المستعمرة الإفرنجية في هذا العهد، وكما فعل جميع الأعاجم الذين قامت لهم دول في الإسلاميّة كآل بويه والسلجوقيين والغوريين والأمراء الجركسة وآل محمد علي، فإنهم ما لبثوا أن استعربوا وتخلّقوا بأخلاق العرب، وامتزجوا بهم وصاروا جزءاً منهم. وكذلك المغول التاتار صاروا فرساً وهنودا، فلم يشذّ في هذا الباب غير المغول الأتراك أي العثمانيين، فإنهم بالعكس يفخرون بمحافظتهم على غيريّة رعاياهم لهم، فلم يسعوا باستتراكهم كما أنهم لم يقبلوا أن يستعربوا، والمتأخرون منهم قبلوا أن يتفرنسوا أو يتألمنوا. ولا يعقل لذلك سبب غير شديد بغضهم للعرب كما يستدل عليه من أقوالهم التي تجري على ألسنتهم مجرى الأمثال في حق العرب:
كإطلاقهم على عرب الحجاز (ديلنجي عرب) أي العرب الشحاذين.
وإطلاقهم على المصريين (كور فلاح) بمعنى الفلاحين الأجلاف.
و(عرب جنكنه سي) أي نَوَر العرب. و(قبطي عرب) أي العرب المصريين.
وقولهم عن عرب سوريا (نه شامك شكري ونه عربط يوزي) أي دع الشام وسكرياتها ولا ترَ وجوه العرب.
وتعبيرهم بلفظة (عرب) عن الرقيق وعن كل حيوان أسود.
وقولهم (بس عرب) أي عربي قذر.
و(عرب عقلي) أي عقل عربي أي صغير. و(عرب طبيعتي) أي ذوق عربي أي فاسد. و(عرب جكه سي) أي حنك عربي أي كثير الهزر.
وقولهم (بوني يبارسه م عرب أوله يم) أي أنّ العرب من الطنبور.
هذا والعرب لا يقابلونهم على كل ذلك سوى بكلمتين، الأولى هي قول العرب فيهم: (ثلاث خلقن للجور والفساد: القمل والترك والجراد).
والكلمة الثانية تسميتهم بالأورام كناية عن الريبة في إسلاميتهم، وسبب الريبة أنّ الأتراك لم يخدموا الإسلامية بغير إقامة بعض جوامع لولا حظ نفوس ملوكهم بذكر أسمائهم على منابرها لم تقم.
(انتهى) بنصه حتى على مستوى الهوامش والتعليقات من “أم القرى” للكواكبي.
إنّ تصور الكواكبي ومعاصريه للأزمة يبدو أفضل بكثير من تصوّر من جاءوا بعده:
فالكواكبي حاول أن يضع في جمعيته (المتخيّلة أو المتمنّاة) ما يمثّل سائر أقاليم الأمّة وفصائلها بقدر الإمكان، بل لقد تجاوز ذلك إلى حد تمثيل الأقليّات المسلمة في الخارج. أما من جاءوا بعد ذلك فقد ألفوا القومية بمفهومها الأوروبي الضيق، وكذلك ألفوا الإقليمية، بل لم يعد بعضهم يحاول أن يتفهم الفوارق بين الخاص والعام لا على المستوى الإسلامي ولا على المستوى العربي.
أمّا الكواكبي فقد جهد ذهنه في معرفة الخاص بكل إقليم أو مجموعة بشرية وكذلك العام بشكل يستحق التقدير خاصةً إذا لاحظنا أن السقف المعرفي في عهده وثورة المعلومات لم تكن قائمة بالشكل الذي هي عليه الآن بحيث يمكن للمعاصرين أن يعرفوا على وجه الدقة والتحديد الخاص والعام فلا يقعون بالخلط الذي يتخبط الكثيرون من المعاصرين فيه حيث يعمّمون الخاص ويخصّصون الخاص دون قيود.
لقد بلغ وضوح الرؤية للأزمة في عصر الكواكبي مستوىً جعله قادراً على التمييز بين الكليّ من عناصر الأزمة ثمّ يصنّفها إلى الفرعي والجزئي وإلى الأصلي بشكل لا نراه وارداً لدى معاصرينا من الذين ملأوا الدنيا حديثاً عن الأزمة والمأزومين، وأنّ كان هناك مجال للملاحظة في بعض ما عدّ فرعياً وهو أصلي أو ما عدّ أصلياً وهو فرعي.
كذلك كان الكواكبي صريحاً في التعبير عن شعور كل من العناصر المشتركة في الكيان الاجتماعي الإسلامي في تلك المرحلة: فأبرز المشاعر المريضة التي بثّها الطورانيّون وأتباع سياسة التتريك بين الأتراك، وذكر ردود الأفعال التي حصلت لدى العرب وغيرهم تأثّراً بتلك الأمور دون مواربة، وحذّر من استفحال ذلك الشر. أمّا معاصرونا فكثيراً ما يدفنون رؤوسهم في الرمال ليخفوا كثيراً من المشاعر المرضية والاتجاهات السلبية السائدة اليوم بين العرب.
طريقة رصد الكواكبي للأزمة لم تركّز على النخبة كما فعل ويفعل من جاء بعد جيله، بل أشرك الأمّة كلها، وجعل لها بكل فصائلها أدواراً في فهم الأزمة والعمل على حلّها، بحيث يمكن للأزمة في إطار تصوره أن تستنفر –كلها- بطاقاتها كلّها لفهم الأزمة والتعاون على معالجتها، لذلك لا نستطيع أن نفتقد في طرحه عملية تغييب الأمّة وتحضير أرواح “النخبة” في الاصطلاح الغربي أو “أُولي الأمر منكم” في المصطلح الإسلامي، كما نفتقد ذلك في خطاب المعاصرين.
هذه بعض المعالم الهامة التي يمكن ملاحظتها بسرعة في طرح الكواكبيّ وجيله لسؤال النهضة وإشكالية الأزمة، يوضح لنا التقهقر الذي شهدناه بعد ذلك، لا على مستوى حل المشكلات والجواب عنها، بل على مستوى فهم الأزمة وصياغة السؤال.






