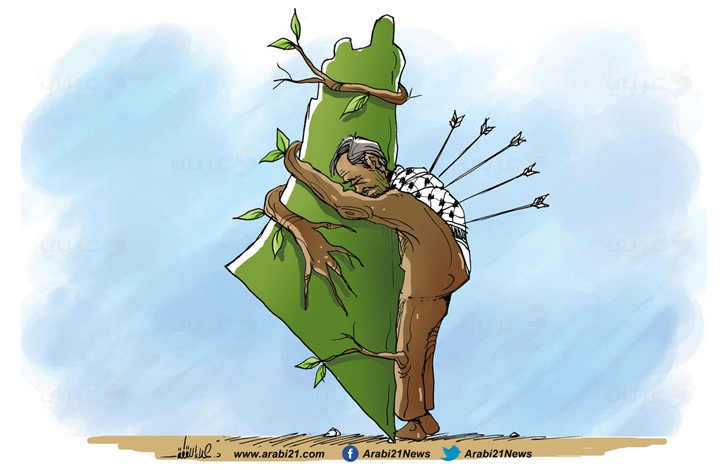أقلام الوطن
نجدة لأردوغان، أمريكا وبريطانيا تديران المعركة… و”إسرائيل” تقصف

سمير الفزاع
منذ الحرب العالمية الأولى على الأقل، انتقلت ادارة منطقتنا العربية الى عدد من العواصم الغربية. ومع انتهاء هذه الحرب، واكتساب خرائط سايكس-بيكو ومراكش… صفة الحدود والكيانات، أصبحت الحرب –أي حرب- في هذه المنطقة قراراً دوليّاً، أو بات للعلاقات الدولية قدراً حاكماً في قرار نشوب أو إطفاء أي حرب أو نزاع فيها على الأقل. وأصبح هذا “الناظم الدولي” أكثر وضوحاً مع “زرع” الكيان الصهيوني وظهور النفط. وبالرغم من انتهاء حقبة الإستعمار المباشر نظريّاً، سعت دول عظمى الى فرض سيطرة شبه كاملة على دول بأسرها بالتزامن مع إنشاء وإدماج “ضوابط” من قوى محليّة-اقليمية ضمن أدواتها العسكرية-السياسية، للتحكم بحركة وشكل المنطقة، ومنع مفاجأتها بأي حدث ضمن مجالها الحيوي. ومن أبرز الأمثلة على بحث القوى العظمى عن وكلاء اقليميين لها، تلك الرحلة التي قام بها الرئيس الأمريكي، جنرال امريكا في الحرب العالمية الثانية، إيزنهاور، على متن البارجة “كيسي” الى تركيا ومصر والسعودية والكيان الصهيوني، والتفاهمات والاتفاقيات التي عقدها في كل محطة من هذه المحطات.
وكان الإنذار الأمريكي-السوفيتي لشركاء العدوان الثلاثي 1956، الإشارة الأكثر وضوحاً لانتهاء نظام دولي وقيام آخر، وبداية “خشنة” لنقل “الضوابط” الإقليمية الى حضيرة العصر الأمريكي، وهو ما تمت ترجمته فعليّاً باتفاقية “برمودا” بين واشنطن ولندن 1957، لتسليم المستعمرات البريطانية للسيد الجديد، أمريكا. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل جعلت واشنطن من ثروات “مستعمراتها” في هذه المنطقة جزءاً اساسيّاً من أمنها القومي، الأمر الذي تُرجم باتفاقات ومواقف علنية، مثل اتفاق “كيسي” واتفاق “جيكور”… وليس انتهاءً بمبدأ “كارتر” 1980.
في ظل هذه الموجة من الهجوم المتجدد تاريخيّاً على منطقتنا، لعبت “الضوابط” الإقليمية دوراً أساسيّاً في تنفيذ الاستراتيجيات الغربية، والأمريكية خصوصاً على المستويات كافة، سياسياً وعسكريّاً واقتصاديّاً وتنمويّاً وثقافيّاً… ومارست دور الوكيل المحلي المناهض لأي تمرد على هيمنة واشنطن، ولأي نفوذ قائم أو محتمل لخصمها الرئيسي، الإتحاد السوفيتي، في طول المنطقة وعرضها… ويمكن أن ندلل على الدور الوظيفي لهذه “النواظم” الإقليمية بدور مملكة آل سعود والكيان الصهيوني، وتركيا “مندريس” الى جانب ايران الشاه، في حلف بغداد، وعدوان 1967، وخديعة حرب تشرين 1973 (كيسنجر-السادات) المؤسسة لاتفاق كامب ديفيد… .
مع انهيار الاتحاد السوفيتي والكتلة الشرقية، واختلال موازين القوى الدولية لصالح واشنطن بالمطلق، بدأت تهيئة المنطقة لاستقبال مشروع جديد، يعيد تشكيلها وفق مصالح واشنطن و”نواظمها الإقليمية”. وكما كان اغتيال أرشيدوق النمسا على يد “غافريلو برانسيب” سبباً لإشعال حرب أُعد لها وكانت تنتظر صافرة الانطلاق فقط، الحرب العالمية الأولى، لعب صدام حسين دوراً مماثلاً، فكان احتلاله للكويت شرارة لإطلاق هذا المشروع. مشروع سايكس-بيكو الأمريكي الخالص تقريباً، المُصمم لبرمجة خرائط وعلائق وشكل المنطقة لعقود أو لقرون حتى. العنوان، مؤتمر مدريد للسلام، وفي العمق، “الشرق الأوسط الجديد” الذي نَظّر له الصهيوني “شيمون بيريز”… ليكون القرن، قرن أمريكا، والتاريخ، تاريخ أمريكا… ليكتبوا نهاية التاريخ، من منطقنا، قلب العالم، الى العالم بأسره.
لم يخطر ببال واشنطن أن تشارك سورية حافظ الأسد في معركة تحرير الكويت، وأن يجعل من هذه المشاركة “أداة ضبط” لهذه المعركة قدر المستطاع، وأن يحمي ما تبقى من الأمة قدر المستطاع ايضاً، وتفاهم نيسان 1996، خير دليل على ذلك. كما لم يتوقعوا مشاركته في مؤتمر مدريد، فقد سعى حينها، الى المطالبة بأقصى ما يستطيع من حقوق في أسوأ ظرف دولي-اقليمي ممكن، لمنع تكاثر “كامب ديفيد”، وشراء الوقت بانتظار تبدل موازين القوى الدولية والإقليمية… . لم يمنع احتلال العراق 2003 سورية بشار الأسد، أن تكون شريكاً أساسيّاً في نصر تموز 2006، وهزيمة الإحتلال الأمريكي للعراق 2011، لقد شاركت سورية بنخب منتقاة من جيشها وعناصر استخباراتها ميدانيّاً في هذه المعارك المفصلّية… فكان الخيار الصهيو-أمريكي بغزو سوريّة ذاتها. وكما “لُجم” الكيان الصهيوني إبان حرب 1991، لمنع تحول الحرب من أداة هندسة وتغيير في المنطقة إلى فصل جديد من الصراع العربي-الصهيوني غير مضمون أو محدد النتائج، “لُجم” الكيان الصهيوني من المشاركة العلنية في غزو سوريّة 2011، وإن كانت مصالحه وبصماته صارخة في كل تفاصيل الغزو… وأُسند الدور الأكبر لتركيا، “الضابط” الإقليمي العضو في حلف النيتو، وصاحبة أكبر حدود وأوثق العلاقات مع سورية، وعاصمة الإسلام السياسي المتصهين… لإطفاء أي بُعد وطني-عربي في الحرب، و”مداعبة” الوتر الخليفي-العثماني-الاسلامي عند الأتراك والشعوب العربية على حدّ سواء، واستخدام التنوع الإثني-الطائفي في سورية كأداة هدم وصراع لهزّ أركان ومؤسسات الدولة السورية… هذه المرحلة أجملها نتنياهو حرفيّاً بتاريخ 20/1/2020 “إن الهدف الكبير هو التغلب على التهديد الإيراني… يجب التغلب عليه كما تغلبنا على التهديد الكبير للقومية العربية…”. ولكن تغييب العامل الصهيو-أمريكي-التركي المباشر لم يدم طويلاً، بل بات حضورهم بشكل مباشر في الميدان أكثر من ضروريّاً أمام حالة الإستعصاء والمراوحة، بل والتراجع التي وصلتها أدوات الغزو الارهابية، فظهرت اعتداءات تحالف العدوان السافرة، والإحتلال المباشر لأجزاء من سورية… ومن أخطرها الإحتلال التركي.
يمكن للمتابع الغيور الإعتقاد بأننا ارتكبنا بعض الأخطاء في العملية الأخيرة لتحرير ادلب، ومنها: سلمنا خطأً بأن أردوغان لن يُقامر، وسيلتزم بقواعد الإشتباك في معركة ادلب… ولن يكون هناك تدخل عسكري تركي مباشر، الذي استغل ثغرة عدم وجود نص يمنع الطيران التركي المُسيّر من التسلل الى سماء سورية، وتأخرنا في فرض منطقة حظر طيران فوق جغرافيا المعركة عبر مظلة الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية… . أعتقد بأن هذه الأخطاء غالباً ما ترتبط بتقدير الموقف السياسي- الميداني للمعركة، واعتقد بأن جزءً كبيراً من المسؤولية يقع على حلفائنا الروس، لذلك، وبعد انكشاف خيوط “اللعبة” الخطيرة التي كان يديرها التحالف الصهيو-أمريكي، تعاملوا مع اردوغان بقسوة بالغة وأهانوه بشكل فاضح.
لم تكن زيارة جيمس جفري ولاحقاً رئيس الأركان البريطاني الى انقره محض صدفة، لقد كانا يقودان مع فريق أمني-عسكري مشترك معركة ادلب، ليس على مستوى تركيا، بل على المستوى الإقليمي… فبعد أن حاربت واشنطن سورية وحلفائها عبر أمواج من الإرهابيين، انتقلت لمحاربتهم بفرق من جيش النيتو، الجيش التركي، بدعم أمريكي-بريطاني-صهيوني نشط ومباشر، وصمت “عربي” مطبق. ويشرفان على زج تركيا لجيشها ومدرعاتها وراجماتها ومدافعها وطائراتها المسيرة في الحرب ضد سورية، ليكشف مسرح العمليات بعض مما خفي من ترتيبات العدوان المبيّت:
1-بعد الإنهيار الكبير لخطوط أدوات الغزو الإرهابي، شُنّت غارات صهيونية بدت وكأنها “بلا معنى” ميداني-سياسي على جبهة الجولان وأطراف دمشق، ولكنها كانت تخدم هدفاً خطيراً للغاية: هجمات صهيونية متكررة على سوريّة تُجبر الدفاع الجوي السوري على التأهب والتمركز الدائم، وتمنعه من نقل بعض مكوناته ومنظوماته الميدانية-التكتيكية “بانتسير، تور-أم…” الى إدلب لصد هجمات مرتقبة للطائرات المسيرة “التركية” على مواقع الجيش العربي السوري وحلفائه في جبهات غرب حلب وسراقب وجبل الزاوية لوقف تقدمهم.
2-غارة “تركية” غرب حلب، ارتقى بسببها ضباط كبار في الجيش العربي السوري وقادة من حزب الله وحلف المقاومة، كانت الإشارة الأبلغ على عمق التنسيق التركي-الصهيوني الذي تشرف عليه الخلية الأمريكية-البريطانية. وكان الثمن الذي قدمه اردوغان للدعم التقني والغارات الصهيونيّة جنوب سورية، ولتشجيعها على شنّ المزيد هذه الغارات لمشاغلة الدفاعات الجوية السورية، واستغلال ضعف قدرتها عن انجاز تغطية مثالية لكامل سماء الجمهورية في وقت واحد… هو تكفل الكيان فنيّاً-ميدانيّاً بتنفيذ هذه الغارة دون تحمّله أيّ من تبعاتها السياسية-الميدانية، ومن أهم الدلائل على صدق هذا الإفتراض، أن الموقع المستهدف كان بعيداً عن ميدان الإشتباك السوري-التركي المشتعل في سراقب.
3-استخدم الاتراك نفس تكتيكات الكيان الصهيوني في مواجهة منظومات الدفاع الجوي السوريّة، ومنها “الإغراق”، ما سمح لهم بإصابة عدد من منظومات بانتسير، وهذا يرفع من مصداقية وجود خبراء صهاينة ضمن فريق العدوان، خصوصاً وأن معظم طائرات تركيا المسيرة مستنسخة أو شارك بتطويرها الكيان الصهيوني من جهة، وأن تاريخ الجيش التركي بالتعامل مع التمرد الكردي في تركيا يخلو من سجل بهذا المستوى من الأداء في مضمار استخدام الطيران المسيّر من جهة ثانية.
ختاماً، راهن أردوغان ومن خلفه، على تراجع سورية وحلفائها أمام موجة التصعيد والتحشيد… فخسروا الرهان. وأرادوا أن تأتيهم سوريّة ومن خلفها حلفائها زاحفة تستجدي وقفاً لإطلاق النار، فكان الردّ على النار بالمزيد من النار… فتساقط “حلفاء” أردوغان من حوله واحداً تلو الآخر، فاضطر أن يستجدي مرة تلو المرة، لقاءً مع الرئيس بوتين يُنقذه شخصيّاً من الغرق، وينقذ تركيا من تصدع دورها كـ”ضابط إقليمي” وبالتالي انهيارها، لكن بوتين ترك القرار لسوريّة الأسد… التي اختارت قلب الواقع الميداني قبل أي لقاء، واستعادة كل نقطة خسرتها، وتمريغ أنف سلاح “الدرونز” الصهيوني-التركي ذراع غرفة العمليات البريطانية-الأمريكية. لهذا، تعاملت موسكو مع اردوغان ومن خلفه، تعامل المنتصر مع المهزوم، مستخدمة ترسانة واسعة من الرسائل الرمزية والميدانية والسياسية… أفقدت اردوغان وتركيا توازنهما، ما أرهب واشنطن وحلفائها، فبدأت تداعيات انكسارهم تظهر في ادلب ومعبر القائم وشمال شرق الفرات… صحيح بأن الحرب لم تنتهي بعد، لكنها معركة كبرى ربحناها وبقي الكثير.