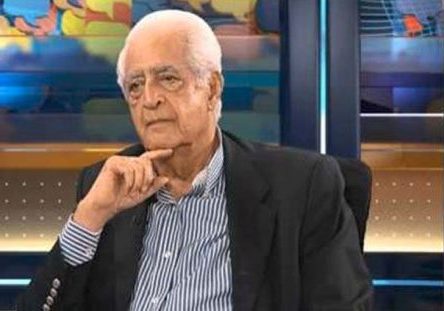ما بعد الغوطة الشرقية شمالاً وجنوباً


د. إبراهيم علوش
كانت قوات الجيش العربي السوري والقوات الحليفة والرديفة تقطع أشواطاً كبيرة في ريف إدلب وجوارها عندما صعّد رعاة العصابات المسلحة في الغوطة الشرقية من القصف على دمشق معتقدين أنهم يخففون بذلك من الضغط على إدلب، وقد جاء الهجوم الإرهابي (وفك الطوق) عن إدارة المركبات في حرستا قبل أيامٍ فقط من تحرير مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب في شهر كانون الثاني الفائت. كما أن انطلاق المرحلة الثانية من الاحتلال التركي في ريف إدلب الشرقي، عبر تثبيت “نقاط مراقبة” تركية في قرى “تل الطوقان” و”الصرمان” و”الصوامع”، حتى قبل التوجه صوب عفرين، جاء في خضم عملية استعادة مطار أبو الظهور. فكان التوغل التركي، في حقيقته، محاولةً بائسةً لـ”تاسيس وزن مقابل” على رقعة الشمال السوري، لا سيما في إدلب، وقد كان هذا الرابط بين إدلب والغوطة الشرقية ماثلاً في المشهد السياسي والميداني منذ البداية، لا سيما من خلال ما يسمى “حركة أحرار الشام” المرتبطة بتركيا، ومن خلال “النصرة” و”فيلق الرحمن” وغيرها من العصابات الإرهابية التكفيرية، والأهم من خلال المنظومة الغربية والصهيونية والرجعية العربية والتركية التي راحت تحرك الحملات الإعلامية والميدانية في المنطقتين.
لذلك كان من المنطقي أن تتقهقر فلول العصابات المسلحة المدحورة، عبر ذلك الخط، من الغوطة الشرقية إلى إدلب، كما اندحرت فلول العصابات الإرهابية قبلها من الزبداني وداريا وقدسيا، ومن حي الوعر في حمص، ومن شرق حلب، إلى إدلب. فإدلب التي تدخل هذه الأيام السنة الرابعة لوقوعها في قبضة العصابات المسلحة، بالتزامن مع العدوان السعودي على اليمن، باتت مستودعاً لتجميع فوائض الإرهابيين الرافضين المصالحة من باقي أنحاء سورية، بكل ما يحملونه من عاهات نفسية واجتماعية وتناقضات مستعصية فيما بينهم وهم الذين يعيشون في ظل إدارات وتمويلات خارجية مختلفة، ناهيك عن التناقض الكبير في ريف حلب بين المشروعين العثماني التوسعي والكردي الانفصالي، وعليه فإن إدلب مرشحة لانفجار تلك التناقضات على شكل صراعات نفوذ ما بين العصابات المسلحة كانت قد اشتعلت معاركها سريعاً بعد سيطرة عصابات “النصرة” على عاصمة المحافظة ومعبر “باب الهوى” الحدودي مع تركيا، مؤخراً ما بين العصابات المسلحة في عفرين نفسها، وعلى شكل حرب عصابات كردية ضد القوات التركية بدأت معالمها تظهر في عفرين وتركيا منذ الآن، وبهذا المعنى، ربما تقرر الدولة السورية ترك إدلب “تستوي على نار هادئة”، مؤقتاً أو بالتوازي مع تقدمها المدروس عبر ريف إدلب والأرياف المجاورة، وعينها أبداً على التغلغل التركي في الشمال، الذي يبدو أنه سيتوجه الآن إلى تل رفعت وسنجار في شمال العراق.
ليس هناك من شكٍ في الحالتين أن استعادة الدولة السورية لمعظم الغوطة الشرقية قرّب من أجل استعادتها السيطرة على محافظة إدلب، وأن خسارة الدول المشغِّلة للإرهابيين للغوطة الشرقية، وتالياً لقدرتها على تهديد دمشق بالقصف المدفعي والصاروخي، سيضعها في موقعٍ أضعف في سوتشي، وجنيف وفيينا، وسيضع الدولة السورية، بعد حسم ملف دوما، وتأمين كل الأنفاق في الغوطة الشرقية لمنع عودة الإرهابيين عبرها، في موضعٍ أقوى لاستكمال استعادة بقية المناطق السورية الواقعة تحت ربقة الإرهابيين أو الاحتلالات الأجنبية.
الأولوية هنا قد تكون لمحيط العاصمة دمشق، وهنا تبقى مناطق مخيم اليرموك والحجر الأسود، وحي القدم، التي تسيطر “داعش” على معظمها، وبالرغم من حساسية موضوع المخيم فلسطينياً، فإن من البديهي أن “داعش” يتخذ ممن تبقى فيه من المدنيين رهائن، وأن المعركة فيه هي مع “داعش” والقوى التكفيرية، بالتعاون مع كل القوى الفلسطينية الشريفة المناهضة للتكفير والإرهاب. وعلى العموم يثبت مثال الغوطة الشرقية أن استعادة المخيم (وغيره) لا يحتاج الكثير من جهد الدولة السورية لولا حرصها على تقليل وقوع خسائر بين المدنيين.
وربما تقرر الدولة السورية، بعد الغوطة الشرقية، تعزيز سيطرتها على تلك الجزيرة الإرهابية المعزولة الواقعة بين جنوب حماة وشمال ريف حمص، والمقابلة لمحافظة طرطوس من الشرق، لتعزيز التواصل بين مدن وأرياف الداخل السوري وإنهاء التواجد الإرهابي فيه تماماً، وقطع أي إمكانية في المستقبل لمد جسر بين ريفي إدلب وحلب الجنوبي ومحافظة حمص، وربما يأتي قبل أو بعد ذلك دور تلك الجزيرة الإرهابية المعزولة الأخرى الواقعة في أجزاء من القلمون الشرقي، في ريف دمشق الشمالي، مقابل سهل البقاع اللبناني من الشرق، والتي رشح أن ما يسمى “جيش الإسلام” في دوما يطالب بالذهاب إليها، وكلا الجزيرتين معزولتان ومطوقتان من جميع الجهات، وقد تمكن الجيش العربي السوري والقوات الحليفة والرديفة من احتوائهما وقطع صلاتهما مع المناطق المجاورة في حملات سابقة مشهودة.
الجزيرتان الإرهابيتان مرشحتان، بالتالي، لسقوط سريع نسبياً، إذا لم تقرر الجهات المشغِّلة للإرهابيين فتح معارك من جهة الأطراف الحدودية لسورية، والمرشح الأكبر لهذا الدور هو العصابات الإرهابية المدعومة صهيونياً من جهة القنيطرة، ومن ثم درعا، ومن ثم احتمالية إعادة تفعيل عصابات “داعش” من قبل الدول الغربية من جزيرته الإرهابية في ريف حمص الشرقي عبر دعمها من مناطق “التحالف الدولي” الملاصقة لها تقريباً شرق الفرات، لا سيما عند نقطة عبور نهر الفرات من سورية للعراق، وربما يكون هناك تفعيل لأكثر من جبهة حدودية في آنٍ معاً، من القنيطرة في الجنوب الغربي، ومن “داعش” من الجنوب الشرقي، ولا خوف ولا قلق من هذا لو وقع لأن الجيش العربي السوري وحلفاءه اكتسبوا، فيما اكتسبوه من خبرات في خضم هذه الحرب اللعينة على سورية، القدرة على إدارة عدد كبير من الجبهات العسكرية المفتوحة في وقتٍ واحد.
أما منطقة التنف، فليس من المرجح تفعيل حملة إرهابية عبرها مباشرة في الوقت الحالي، أولاً لأن العصابات الإرهابية الموجودة فيها اضعف من أن تقوى على شن حملات بمفردها، لا سيما في بادية مفتوحة، وثانياً لأن الانطلاق عبرها مباشرةً سوف يعني غزواً أمريكياً وبريطانياً عسكرياً لسورية مما يرفع الرهانات الميدانية في مواجهة سورية وروسيا ومحور المقاومة إلى مستويات غير مسبوقة لا يمكن التنبوء بعواقبها، ولذلك فإن الأرجح أن يستمر العمل الغربي عبر أدوات ثبت بالمحصلة، وفي كل معركة كبرى، أنها ليست نداً للجيش العربي السوري وحلفائه.
الانهيار السريع للعصابات المسلحة في الغوطة الشرقية، وهي التي كان يتم تصويرها كأنها “معقلٌ حصينٌ لا يمكن اختراقه”، يؤكد أن الإرهابيين وحدهم أقل بكثير من أن يشكلوا نداً للدولة السورية، وأن الدول المشغِّلة للإرهاب ربما تستطيع إطالة أمد الحرب على سورية، لكنها لا تستطيع تغيير نتيجتها، وهي النصر الكامل لسورية وحلفائها.
والغوطة الشرقية، كقيمة عسكرية وسياسية، هي أكثر بكثير مما تمثله تلك الأجزاء من درعا أو القنيطرة الخارجة (مؤقتاً) عن سيادة الدولة بدعمٍ من الخارج، وأكثر بكثير من التنف من دون الأمريكيين، وربما تعادل إدلب من دون الأتراك، أو تلك الأجزاء التي تسيطر عليها بعض الميليشيات الكردية في محافظات الرقة والحسكة ودير الزور من دون القواعد الأمريكية، وقد مثّل التهاوي السريع للعصابات الإرهابية في الغوطة درساً لإرهابيي المناطق الأخرى بأن الجهات المشغِّلة لهم تعاملت معهم كوقود رخيص للمدافع، وأن الدولة السورية لعبت أوراقها باحترافٍ سياسيٍ وميدانيٍ، وأن حلفاءها وقفوا معها بصلابة، فيما تخلى مشغلو الإرهابيين عنهم، ولم يفلحوا بالتدخل مباشرةً، مع أو من دون قرار دولي، فتهاوى الإرهابيون تباعاً، وصاروا أمام ثلاثة خيارات: إما إدلب أو المصالحة أو القتال، والدولة من الواضح تماماً أنها تفضل المصالحات، التي تتضمن بالضرورة شرط إلقاء السلاح ووقف الأعمال الإرهابية والانخراط في الحياة المدنية، وليس هناك من “تهجير” قط، أما من يختار طريق التكفير، فهو الذي يختار “الهجرة” إلى مجمع الإرهابيين في إدلب، والتهجير الحقيقي هو الذي تمارسه الجماعات المسلحة، والذي مارسه الأتراك في عفرين، والذي دفع بملايين السوريين إلى حضن مناطق الدولة، بدلاً من العكس.
28 آذار 2018